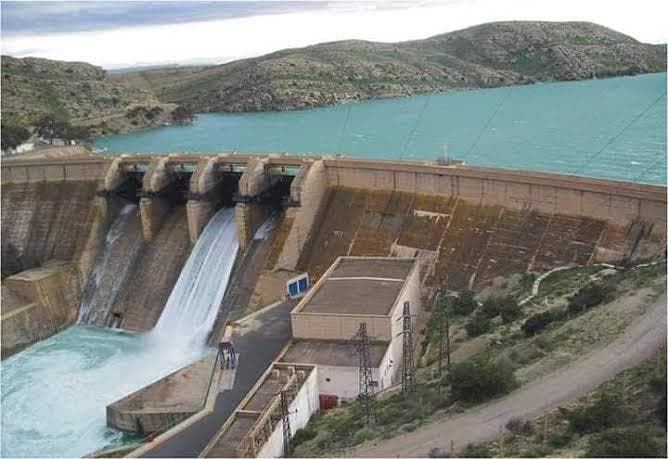وضع أكاديميون اقتصاديون ومحللون في الشأن المالي بالمغرب المعطيات والمؤشرات الماكرو-اقتصادية المتوقعة ضمن أولى محطات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والواردة في المذكرة التوجيهية التي عمّمها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، نهاية الأسبوع الماضي على الوزراء والقطاعات الحكومية المختلفة، تحت مجهر التحليل والدراسة، مؤكدين أن “اللايقين العالمي ما يزال مسيطرا على جزء كبير من إمكانية تحقيق البيانات الماكرو-اقتصادية”، فضلا عن مساءلة الانعكاس الاجتماعي للفرضيات الاقتصادية.
واستندت “المذكرة التوجيهية” لتحضير مشروع قانون مالية 2026 إلى “نهج واقعي حذر وصارم” بتأكيدها “ضرورة ضبط الإنفاق” وتوجيه الميزانية نحو الأولويات الوطنية، في ظل تحديات اقتصادية وجيو-سياسية ومناخية متزايدة، مع اعتماد مقاربة “ميزانية البرامج المبنية على النتائج” عبر التركيز على الأداء وتحقيق الأثر الملموس بدلا من مجرد “تخصيص الموارد”.
وحسب الوثيقة الرسمية ذاتها،فإن الأولويات الأربع للاقتصاد المغربي ستتمثل في “ترسيخ إشعاع وحضور المملكة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى”، مع أهمية لافتة يكتسيها “الحفاظ على توازن المالية العمومية”.
وتوقع الجهاز الحكومي، بناء على هذه الأولويات، أن “يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يقارب 4.5 في المائة سنة 2026، مع خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في نسبة المديونية عند 65,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية السنة المالية القادمة”.
المتوقع والمحقق
قال بوزيان دعباجي، أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، إن هذه المؤشرات، وعلى رأسها نسبة النمو، “تبقى مقياسا لمدى تطور الأداء الاقتصادي خلال سنة معينة. غير أنّ الملاحظ هو اتساع الفارق، بشكل متكرر، بين ما يتحقق فعليا وما تم توقعه في إطار قوانين المالية؛ بفعل عوامل داخلية وخارجية متشابكة”.
وشرح دعباجي، ضمن تصريح لجريدة النهار، أنه من الناحية الخارجية، “برزت تقلبات الأسعار الدولية والإكراهات الجيو-سياسية على المستوى العالمي، إلى جانب اضطرابات الأسواق العالمية. أما داخليا، فتبرز جملة من التحديات، في مقدمتها كلفة الإجراءات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية، فضلا عن إكراهات المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب، وكذا الاستثمارات الضخمة التي تُنجز حاليا بتوجيهات ملكية سامية، ما يضع البلاد أمام رهانات كبيرة في ظل هذه الأرقام”.
وفي السياق ذاته، يبقى من الضروري، حسب أستاذ الاقتصاد، “التركيزُ على التحديات الاجتماعية البارزة، وفي مقدمتها تقليص معدلات البطالة، وحماية القدرة الشرائية، والحد من نسب التضخم، إضافة إلى التعامل مع الضغوط الاجتماعية المتزايدة، بما في ذلك المطالب بإصلاحات جوهرية في قانون الشغل وغيره من الملفات ذات الصلة”.
واستدل بوزيان دعباجي بما جرى خلال السنوات الأخيرة، قائلا: “لمْ تتحقق فرضيات قوانين المالية في جزء كبير منها، ويرتبط ذلك بالظرفية العالمية وما تفرزه من مستجدات، فضلا عن مجموعة من الإكراهات ذات الطابع الظرفي بالغ التأثير”، خالصا إلى أنه “من الصعب بلوغ الأهداف المعلنة أو المتوقعة خلال سنة مالية واحدة، أساسا بسبب التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية بمختلف مكوناتها؛ ما يعني استمرار هيمنة العامل الخارجي في صناعة أداء الاقتصاد المغربي”.
كما سجل أن “المؤشرات الأولية التي بُنيت عليها فرضيات قانون المالية تظل صالحة ما لم يثبُت العكس، كما أن هذه المؤشرات المعلَن عنها تبدو في ظاهرها ذات طابع تحفيزي للاقتصاد الوطني غير أنّها تثير جملة من التساؤلات حول الفرضيات الأساسية التي بُنيت عليها”.
“المسألة المحورية هي التساؤل عن الثمن أو التكلفة، خاصة على الصعيد الاجتماعي: هل ستُرتَّب الأولويات وفق أرقام تدعم تحسين الأوضاع الاجتماعية، لا سيما في ظل انخراط المغرب خلال السنوات الأخيرة في أوراش كبرى كتعزيز الحماية الاجتماعية وتعميمها، وتقليص معدلات البطالة، ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين؟ كلها أسئلة تبقى مفتوحة حول مدى انعكاس هذه الفرضيات الاقتصادية على الواقع الاجتماعي”، يختم المحلل الاقتصادي نفسه.
“سؤال التوجهات”
جواد لعسري، أستاذ التعليم العالي في تخصص المالية العامة والتشريع الضريبي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لفت الانتباه إلى أن “قوانين مالية السنة تتميز بخاصيّةِ أنها توقعية تعتمد مجموعة من المعطيات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والمالية، ليس وطنيا فقط بل من منظور عالمي وإقليمي أشمل” في ظل ما عرفه الاقتصاد المغربي من انفتاح وتنويع للشراكات في العُشرية الأخيرة.
وقال لعسري، ضمن تصريح لجريدة النهار، إن “العامل المتحكم في الاقتصاد الوطني يؤثّر في رسم توقعات الحكومة”، ذاكرا “الوضع المرتبط بالسنة الفلاحية وإمكانية اللجوء إلى الاستيراد، إلى جانب التقلب الذي تعرفه أسعار بعض المواد الأساسية في السوق الدولية، (المنتجات الطاقية والمحروقات السائلة أساسا)”.
وسيرا على قراءات عدد من المحللين الاقتصاديين، نبّه أستاذ المالية العامة إلى ضرورة استحضار “القراءة السياسية للحكومة لمؤشرات ومعطيات اقتصادية ومالية صِرفة في مسار الإعداد لمشروع الميزانية للعام 2026 الذي يعدّ سنة استحقاقات تشريعية، حسب الأجندة الرسمية المحددة”.
وتابع معلقا: “توقعات معدل النمو في حدود 4.5% خلال سنة 2026 تستحضر الدينامية المتواصلة للأنشطة غير الفلاحية، وتعافي عدد من القطاعات، فضلا عن أداء قوي لقطاعات إنتاجية وصناعية وخدماتية، إلا أنه وجب الانتباه إلى معطى متوسط إنتاج المحاصيل والسنة الفلاحية الذي سيكون أيضا حاسما لوضع مدى صدقية المؤشرات المتوقعة على المِحك”.
وزاد بالتأكيد أن “التوترات الجيو-سياسية وتقلبات الأسعار الدولية التي قد تندلع في أيّ لحظة، يتعيّن ألّا تغيب عن ناظِري المدبّر العمومي، والفاعل الحكومي تحديدا (…) خاصة أن ذلك قد يؤثر في الفاتورة الطاقية أو بعض المواد المستوردة، فضلا عن أسعار الفوسفاط في السوق العالمية وغيرها”.
كما أثار المصرح لجريدة النهار سؤال “ترشيد النفقات العمومية” من خلال ضرورة التنصيص على “مراجعة أو تأجيل الأنشطة والنفقات غير ذات الأولوية أو التي لم تثبت جدواها”.
وفي سياق متصل، لم يفت أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي التنبيه إلى أن بعض مقتضيات المذكرة التوجيهية لا تتوافق مع ما ورد قانونيا في شق متعلق بـ”دراسة قوانين المالية، حيث تنص المادة 46 على أنه يتولى الوزير المكلف بالمالية، تحت سلطة رئيس الحكومة، إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور”، مؤكدا أن “المذكرة لا تستحضر ذلك، ما قد يضع الحكومة في تعارض مع المقتضى الدستوري”، بتعبيره.